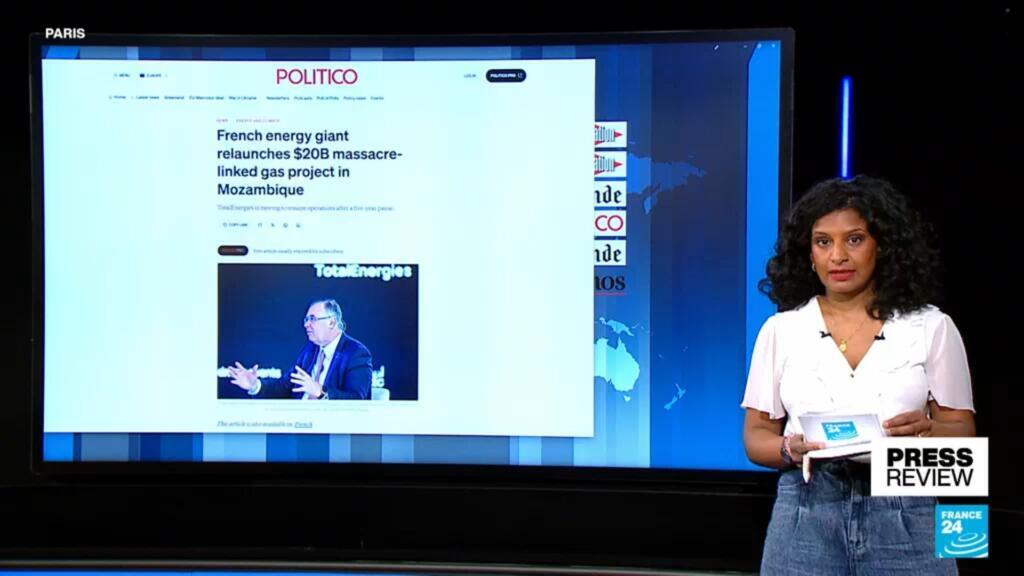خلال العام الماضي، سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى “إحلال السلام” في جميع أنحاء العالم. ومن السمات البارزة لجهوده الاعتقاد بأن التهديدات أو المكافآت الاقتصادية يمكن أن تحل الصراعات. وفي الآونة الأخيرة، قامت إدارته بتطوير خطط التنمية الاقتصادية كجزء من وساطة السلام في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة، والحرب في أوكرانيا، والصراع بين إسرائيل وسوريا.
وفي حين قد يرى البعض أن نهج ترامب “العملي” في التعامل مع “صنع السلام” فريد من نوعه، إلا أنه ليس كذلك. لقد كان الاعتقاد الخاطئ بأن التنمية الاقتصادية يمكن أن تحل الصراع سمة منتظمة لمبادرات السلام النيوليبرالية الغربية في الجنوب العالمي على مدى العقود القليلة الماضية.
وفلسطين المحتلة مثال جيد.
في أوائل التسعينيات، عندما بدأت “عملية السلام”، بدأ وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز يدعو إلى “السلام الاقتصادي” كجزء منها. لقد روج لرؤيته لـ “الشرق الأوسط الجديد” على أنها نظام إقليمي جديد يضمن الأمن والتنمية الاقتصادية للجميع.
ويهدف المشروع إلى وضع إسرائيل في المركز الاقتصادي للعالم العربي من خلال البنية التحتية الإقليمية – النقل والطاقة والمناطق الصناعية. كان حل بيريز “للصراع الإسرائيلي الفلسطيني” هو التكامل الاقتصادي الفلسطيني. وحصل الفلسطينيون على وعود بفرص العمل والاستثمار ومستوى معيشة أفضل.
وقال إن التنمية الاقتصادية والتعاون من شأنه أن يعزز الاستقرار والمصالح المتبادلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لكن ذلك لم يحدث. وبدلاً من ذلك، مع استمرار الاحتلال بعد اتفاقات أوسلو التي توسطت فيها الولايات المتحدة وإنشاء السلطة الفلسطينية، تزايد الغضب في الشوارع الفلسطينية وأدى في النهاية إلى اندلاع الانتفاضة الثانية.
تم اختبار هذا النهج النيوليبرالي مرة أخرى من قبل اللجنة الرباعية ــ التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وروسيا ــ وسفيرها توني بلير في عام 2007. وبحلول ذلك الوقت، كان الاقتصاد الفلسطيني قد انهار، فخسر 40% من ناتجه المحلي الإجمالي في ثماني سنوات، وسقط 65% من السكان في براثن الفقر.
كان “الحل” الذي قدمه بلير هو اقتراح 10 مشاريع اقتصادية “سريعة التأثير” وجمع الأموال لها في الغرب. وقد تزامن ذلك مع سياسات رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك سلام فايد، والتي أصبحت تعرف باسم “الفايدية”.
وقد تم بيعها للفلسطينيين باعتبارها طريقاً لإقامة الدولة من خلال بناء المؤسسات والنمو الاقتصادي. وركز فياض على المكاسب الاقتصادية قصيرة المدى في الضفة الغربية المحتلة بينما عمل في الوقت نفسه على إعادة هيكلة النظام الأمني الفلسطيني لتلبية الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية.
إن هذا النموذج من السلام الاقتصادي لم يعالج قط السبب الجذري للركود الاقتصادي الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي. وحتى البنك الدولي حذر من أنه ما لم يتم وضع حد للسيطرة الإسرائيلية، فإن الاستثمار سوف يفشل على المديين المتوسط والطويل من دون التوصل إلى تسوية سياسية. ومع ذلك استمر الإجراء.
وقد أفاد ذلك الفلسطينيين، لكنهم لم يكونوا فلسطينيين عاديين. لقد كانوا نخبة ضيقة: مسؤولون أمنيون يتمتعون بامتياز الوصول إلى المؤسسات المالية، ومقاولين مرتبطين بالسوق الإسرائيلية، وحفنة من كبار المستثمرين. بالنسبة لعدد أكبر من السكان، كانت مستويات المعيشة محفوفة بالمخاطر.
وبدلاً من إعداد الفلسطينيين لإقامة الدولة، استبدلت مذهب الفياضية التحرر بالإدارة، والسيادة بالتنسيق الأمني، والحقوق الجماعية بالمتعة الفردية.
وقد أعطى هذا النهج الاقتصادي لحل الصراع إسرائيل الوقت للانغماس في مشروعها الاستعماري من خلال استيطان الأراضي الفلسطينية.
الخطة الاقتصادية الأخيرة لغزة، التي قدمها مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، قد لا تحقق الرخاء الاقتصادي للفلسطينيين أيضًا. يعكس المشروع ديناميكيتين متعارضتين بشدة: فهو طليعة فرص الاستثمار والربح لأقلية القلة العالمية والإقليمية بينما يتجاهل بشكل منهجي الحقوق الوطنية والإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني.
فالأمن يعتمد حصراً على احتياجات قوة الاحتلال، في حين يتم تقسيم الفلسطينيين وتأمينهم ومراقبتهم – وتحويلهم إلى قوة عمل غير سياسية مجردة من الهوية الاجتماعية والوطنية.
ترى هذه الرؤية الناس كأفراد وليس كأمم أو مجتمعات راسخة تاريخياً. وبموجب هذا المنطق، يُتوقع من الأفراد أن يذعنوا للقمع والاحتلال بمجرد حصولهم على وظائف وتحسين مستوى معيشتهم.
وهذه الاستراتيجيات تفشل في إحلال السلام في فلسطين فقط.
وفي مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، اقترحت الولايات المتحدة توسيع المنطقة منزوعة السلاح وتحويلها إلى منطقة اقتصادية مشتركة، بما في ذلك منتجع للتزلج. ولا يهدف النهج الأميركي إلى الضغط على سوريا لحملها على التخلي عن حقوقها السيادية على المنطقة فحسب، بل يهدف إلى إعادة صياغتها كمشروع أمني يفيد إسرائيل في المقام الأول. وفي هذا الإطار، ستكون الولايات المتحدة بمثابة الضامن الأمني. لكن تحالفها الوثيق مع إسرائيل يلقي بظلال من الشك على حيادها ونواياها الحقيقية.
وفي أوكرانيا، اقترحت الولايات المتحدة إقامة منطقة اقتصادية حرة في أجزاء من منطقة دونباس، سينسحب منها الجيش الأوكراني. وهذا من شأنه أن يسمح لموسكو بتوسيع نفوذها دون صراع عسكري مباشر، وإنشاء منطقة عازلة مواتية للمصالح الأمنية الروسية.
لقد كانت دونباس تاريخياً إحدى القواعد الصناعية في أوكرانيا، وتحويلها إلى منطقة اقتصادية حرة من شأنه أن يحرم أوكرانيا من أصل اقتصادي مهم. وليس هناك ما يضمن أن الجيش الروسي لن يتقدم ويسيطر على المنطقة بأكملها بعد انسحاب أوكرانيا.
إن هذه “الحلول” النيوليبرالية للصراعات في غزة ودونباس ومرتفعات الجولان سوف تفشل تمامًا مثل مبادرات السلام ذات الدافع الاقتصادي في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين في فلسطين المحتلة.
المشكلة الرئيسية هي أن الولايات المتحدة لا تستطيع حقًا تقديم ضمانات موثوقة بأن المناطق ستظل مستقرة، حتى يتمكن المستثمرون من تأمين عائد على استثماراتهم. ولأن هذه المقترحات تتجاهل المصالح السياسية والثقافية والأهم من ذلك المصالح الوطنية لسكان هذه المناطق، فلن تكون هناك تسوية سياسية ملموسة في ضوء هذه الحقيقة. وبالتالي، لن يلتزم أي مستثمر جاد أو مستقل برأس مال لمثل هذا الترتيب.
الأمة ليست مكونة من مستهلكين أو عمال؛ وهم يتألفون من أشخاص ذوي هوية مشتركة وتطلعات وطنية.
وينبغي للحوافز الاقتصادية أن تتبع، ولا تسبق، أي حل سياسي يضمن حق السكان الأصليين في تقرير مصيرهم. إن أي إطار لحل الصراعات يتجاهل الحقوق الجماعية والقانون الدولي محكوم عليه بالفشل. ويجب أن تعطي التسويات السياسية الأولوية لهذه الحقوق، وهو مطلب يتعارض بشكل مباشر مع منطق الليبرالية الجديدة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة السياسات التحريرية لقناة الجزيرة.